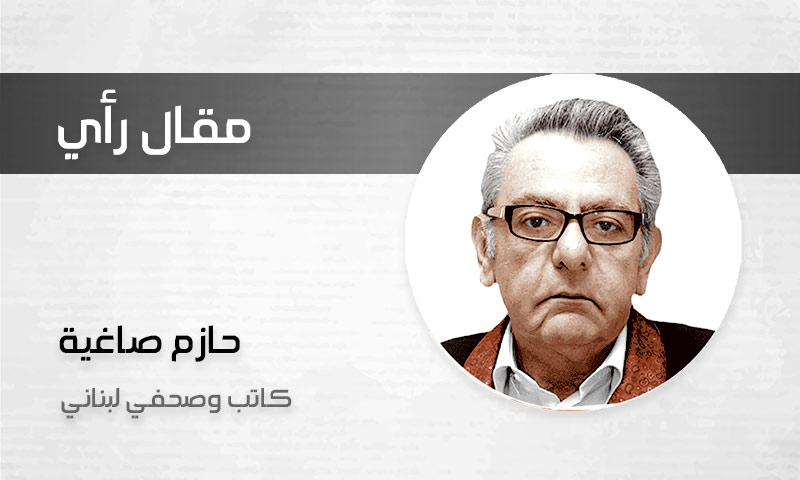نتخيّل شابّاً في عشريناته، تعلّم في بيت أهله بعض القيم، ثمّ كرّستها فيه المدرسة التي درس فيها، ومن بعدها الجامعة. وهي قيم ظنّ أنّ الدنيا تنتظرها كونها تحضّ على ما هو خيّر ومفيد.
الشابّ هذا كان طفلاً حين تولّى الحكمَ مَن صار الحاكم. لكنّه حين أُعلن عن «انتصاره» بعد ثورة وحرب أهليّة دامتا ستّ سنوات، استغرب واندهش. ولكثرة ما فكّر في الأمر، مستعيناً بالقيم التي يحملها، أصابه ما يشبه المسّ الذي يعصف بكلّ ما تعلّم أنّه صائب، أو اعتقد بأنّه صحيح.
فقد بدا له غريباً جدّاً أن يُكافأ بالنصر من تسبّب بمقتل نصف مليون إنسان، وبتهجير نصف سكّان بلده من بيوتهم، وربعهم من البلد ذاته. وقد استبدّت به الغرابة حتّى تملّكته حين تصاحب هذا النصر مع تدمير ذاك الحاكم إحدى أجمل مدن العالم.
قال لنفسه: ربّما كان هناك ما لا أعرفه. ربّما كان الحاكم قائداً تاريخيّاً كافأته مواصفاته الفذّة بهذا الانتصار؟ لكنّه ما لبث أن تذكّر أنّه لم يأت مرّةً ما يوحي بتلك الفذاذة قبل أن يرث الحكم عن أبيه. لم يُعرف بشيء، مطلق شيء. فهو لم يملك حتّى موهبة بعض الذين وصلوا إلى السلطة عن طريق المؤامرات داخل أحزابهم وجماعاتهم، إذ لم يُحوجه التوريث السهل إلى التفكير في ذلك.
صاحبنا قال: قد يكون وراء ذلك تكريمٌ لأبيه وللرصيد الذي خلّفه، هو الموصوف بأنّه صاحب «انتصارات تاريخيّة» في «معارك قوميّة». لكنّه، هنا أيضاً، ما لبث أن استدرك وتذكّر أنّ الأب الراحل لم ينتصر على دجاجة في كلّ «حروبه القوميّة» تلك، كما لم يملك من عناصر الكاريزما أكثر ممّا يملكه نجله. لقد كانت الصفة الأبرز التي تُنسب إليه قدرته على الجلوس ستّ ساعات متواصلة على الكرسيّ ذاته. فهو، إذاً، صاحب موهبة رياضيّة أو جسمانيّة بدّدها في سياسات المكائد والحروب الخاسرة.
مضى يتساءل: هل أنّ الحاكم قارىء؟ لا. كاتب؟ لا. عالم؟ لا. خطيب؟ لا.
صفن صاحبنا قليلاً وقال لنفسه:
ربّما كان في الأمر تكريم للفنون، للآداب، للموسيقى؟ لا. لا. لا. للوسامة؟ لا. للنجوميّة؟ لا. لحسّ الفكاهة؟ لا. لسلامة النطق؟ لا…
الشابّ العشرينيّ لم يفهم. فما هو معروف عن الحاكم المنتصر وما هو ظاهر للعيان لا يقدّم أيّ إسهام في حلّ المعضلة. وإذ أحسّ بما يشبه الدوار نتيجة عجزه عن الفهم، قال لنفسه، في محاولة أخيرة للتوصّل إلى تفسير منطقيّ: لكنّه، بعد ستّ سنوات من القتال، تمكّن من الانتصار. ألا ينمّ هذا عن طاقة قياديّة ما؟
وهنا أيضاً عاودت الحقائق المثيرة للاضطراب إلحاحها عليه: لقد انتصر بفضل دول وميليشيات أجنبيّة لا حصر لها، كانت هي التي قادت وخطّطت.
لم يستطع صاحبنا الوقوع على سبب مقنع يهدّىء حيرته المعذِّبة والتي تهدّد نظام قيمه بالاختلال. أحسّ أنّ ثمّة خطأ في نظام الكون. في معنى الأشياء. شكّك في أن تكون الأرض مستديرة. شكّك في صحّة المساواة بين الرجل والمرأة. في أهميّة العقل. في فائدة التقدّم. تلمّس أجزاء من جسمه ليتأكّد من أنّه هو نفسه موجود.
أسرع قاصداً معالجه النفسيّ. الأخير كان في غاية الصراحة والوضوح. قال له إنّ ثمّة حلّين: إمّا أن تقتل الحاكم أو أن تقتل نفسك. في الحالة الأولى، تزيل التناقض الذي يُلحق الشلل بك. في الثانية، تزيل الشلل وتترك التناقض لآخرين يتعاملون معه من بعدك.
صاحبنا فكّر بأنّ الانتماء إلى تنظيم عدميّ وتكفيريّ ربّما كان نقطة التقاطع بين الاغتيالين اللذين اقترحهما عليه الطبيب. وفي طريقه إلى ذاك التنظيم شوهد، للمرّة الأخيرة، مُرّاً ومتجهّماً كأنّه يزرع سكّيناً في صدر الحاكم وسكّيناً في صدره هو، مفجوعاً بالعالم ومفجوعاً بفراقه. لكنّه، مع هذا، بقي مُصرّاً على المضيّ في تمتمته المكسورة:
«تضرب أنت وهالخطابْ
الحرّيّة صارت عالباب…».
*****
كثيرون جدّاً، اليوم، أولئك الشبّان الذين يعانون ما يعانيه صاحبنا. الدنيا موصدة أمامهم. التفاؤل بهذا العالم ليس في محلّه. نعم، هناك خلل كبير في الحياة. في المعنى. في القيم.