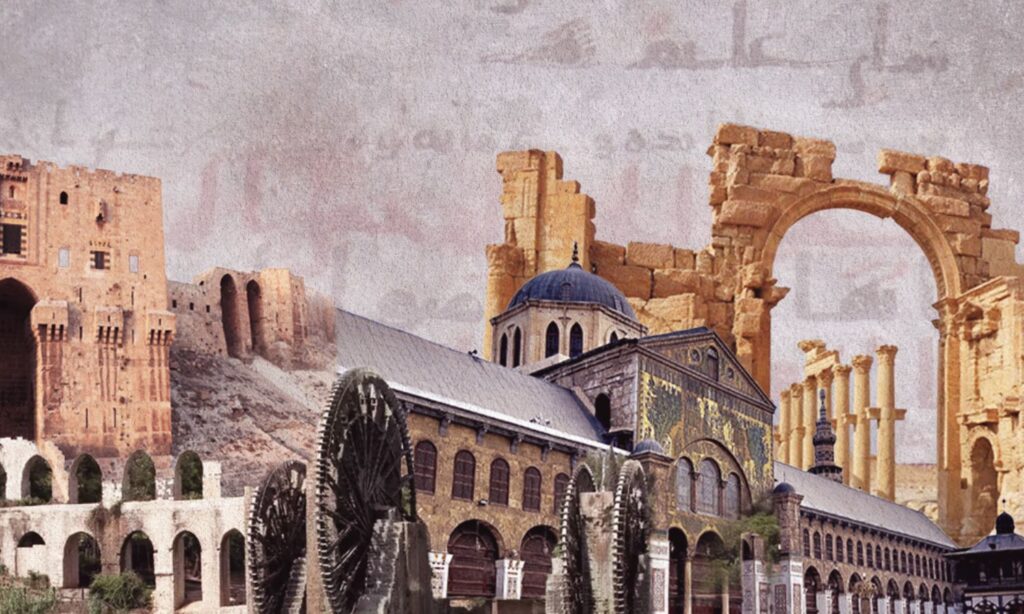عنب بلدي – شعبان شاميه
تعد اللهجات السورية من اللهجات العربية الأكثر تميزًا، إذ تعكس تاريخ البلاد الغني وتراثها الثقافي المتنوع.
تعود جذور اللهجات السورية إلى اللغة العربية الفصحى، ولكنها اكتسبت خصائص فريدة بفضل التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت بها عبر العصور.
ولا يوجد عدد واضح للهجات المتداولة في سوريا، سوى تلك اللهجات العامة: الشامية، الحلبية، الساحلية، الإدلبية، الحورانية، الدرزية، الديرية، الشاوية، لكن حتى أبناء هذه اللهجات يختلفون فيما بينهم باللهجة إلى حد ما.
الغريب وغير العلمي أن هذه اللهجات وصمت بمرجعيات طائفية بطريقة سطحية لا دليل عليها سوى الصفة الاجتماعية الشائعة عن المنطقة، من دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ هذه المدن والحضارات المتعاقبة عليها واختلاطها وامتزاجها بحضارات متعددة كانت اللغة واللهجة أول المتأثرين بها.
الاختلافات الأساسية بين اللهجات السورية تقوم في أولها على حرفي القاف والتاء المربوطة، ففي الشامية تُلفظ القاف ألفًا أو همزة، وفي الحلبية تفخَّم القاف فتبدو وكأنها مضمومة أو مشدَّدة، وفي الديرية تأتي ثقيلة ومضمومة كأنها تبلع ما بعدها.
وفي الساحل، هناك من يلفظها قافًا صريحة ومن يلفظها ألفًا مضمومة نسبيًا، ويبدو الاختلاف واضحًا في أسماء الإشارة أكثر من غيرها، على سبيل المثال “هذا هو”، هي “شحّو” بالشامية، و”كوه نيه” بالحلبية، و”ليكو” باللاذقانية، و”هذين نو” بالديرية، وتأتي بلفظ مفخّم بالحورانية يصل إلى حد لفظ الذال ظاء فيكون اللفظ “هاظ هو”.
وتتميّز اللهجة الشاوية بلفظ القاف كافًا، كقولهم “وگف”، بدلًا من “وقف”، أو جيمًا كقول “چدور”، بدلًا من “قدور”، وهناك مفردات يُقلَب فيها حرف الغين قافًا كقول “قسالة”، بدلًا من “غسالة”، كما يُبنى الاختلاف في كثير من الأحيان على مسميات الأشياء.
اختصاصي فقه اللغة الأستاذ في كلية الآداب بجامعة “طرطوس” الدكتور ماهر حبيب، قال لعنب بلدي، إن البحث في اللهجات شائك وطويل وليس بحثًا علميًا أصيلًا، باعتبار أن العوامل المؤثرة في تكوين اللهجات كثيرة جدًا، ولا يمكن تحديد معظم أسبابها تحديدًا علميًا.
واللهجة، وفق الدكتور حبيب، هي استعمال فردي- جماعي من اللغة الأساسية أو هي استعمال لوجه من وجوه هذه اللغة، مبينًا أنه في القرآن الكريم لم ترد كلمة لغة وإنما وردت كلمة “ألسنة”، والألسنة هي مرادفة لما نقول عنه اليوم “اللغة”، بينما لفظة اللغة لدى اللغويين القدماء أُطلقت على “اللهجة”.
العوامل المؤثرة في تكوين اللهجات
قديمًا كانت هناك لهجات كثيرة عند العرب، وفق حبيب، بعضها فصيح وبعضها ما هو أفصح، أو مقبول أو يُوثَق به، في حين أن اللغويين القدماء لم يعنوا بدراسة هذه اللهجات إلا من باب تخريج قراءة قرآنية ما، مؤكدًا أن ما حُفظ لنا اللهجات العربية القديمة هي القراءات القرآنية.
وأوضح حبيب أن العوامل مختلفة، فهناك من أرجع تعدد اللهجات إلى عوامل جغرافية، وآخرون إلى عوامل نطقية، وبعضهم أرجعها إلى تأثير لغة الأطفال والقلب المكاني (ظاهرة لغوية تحدث عندما يتم تقديم بعض حروف الكلمة على غيرها، وهو شائع في لغة الأطفال نتيجة لعدم القدرة على نطق الحروف بترتيبها الصحيح)، مشددًا على أن لا أحد يستطيع أن يفسر أسباب اختلاف اللهجات.
وأشار حبيب إلى أنه في لهجة أهل الساحل اعتبارًا من أنطاكية وصولًا إلى جبل عامل وفلسطين يميلون إلى الكسر، في حين يبلغ الكسر ذروته في اللهجة اللبنانية، وتشذّ عن تلك القاعدة لهجتا مدينتي اللاذقية وجبلة إذ تختلفان بوضوح، من جهة عدم ميلهما إلى الكسر، عن لهجتي مدينتي بانياس وطرطوس اللتين تميلان إلى الكسر، مستبعدًا إمكانية تحديد العوامل، معتبرًا أن البحث اللغوي يصف اللهجة ولا يحدد عوامل نشأتها إطلاقًا.
كما لفت اختصاصي فقه اللغة إلى اختلافات اللهجات المبنية على تباين مسميات الأشياء، بالقول إن “البرّاد” في لهجة أهل طرطوس هو الجهاز المعروف الذي يقوم بالتبريد، واستخلصت الكلمة من الفعل، في حين يعبّر به عند الحلبيين عن الإبريق كونه يُستخدم في بيئتهم لحفظ الماء البارد، والإبريق في اللهجة الساحلية أمر مختلف تمامًا.
وبيّن الدكتور حبيب، أن قريتين متجاورتين مكانيًا قد تختلفان كليًا باللهجة، وغالبًا ما يكون مردّ هذا الاختلاف إلى كيفية نطق الصوائت (الحركات)، كإطالتها أو تقصيرها أو إمالتها أو تفخيمها، كالاختلاف بين لهجتي طرطوس وبانياس من جهة واللاذقية من جهة أُخرى، في حين تمتلك بعض المناطق خصائص مثل إدغام بعض الأحرف كحي الصليبة في مدينة اللاذقية، الذي يقول أهله “أتِّ” عوضًا عن “أنت” (أُدغمت النون في التاء وشُددت).
وحول إن كان هناك تخصصات أكاديمية لدراسة اللهجات، أجاب حبيب بأنها غير مرغوبة أبدًا كونها تحوّل الانتباه عن اللغة الأصلية والتي هي لغة القرآن الكريم.
وكانت هناك محاولات كثيرة، بحسب ما ذكره الاختصاصي لعنب بلدي، لتكريس هذه اللهجات كلغات، مشيرًا إلى محاولات لتحويل اللهجة اللبنانية إلى لغة، وهذا أمر مرفوض وغير علمي.
ارتكازات تاريخية
لا يوجد سند تاريخي يمكن الاعتماد عليه كمنطلق لظهور اللهجات المحكية في سوريا تحديدًا، فبعض المراجع تعيد الأمر إلى تلاقح بين اللغات القديمة، مثل الآرامية والعربية الفصحى، بُعيد سيطرة العرب على المنطقة بفعل التمدد الجغرافي للعرب من شبه الجزيرة العربية في فترة تُعرف باسم “الفتوحات الإسلامية”، لكن العرب يتهمون السنوات الـ400 التي خضعوا فيها للاحتلال العثماني بالتسبب في تحريف اللغة ومحاولة تتريك بعض من مفرداتها، حتى إن بعض أدوات المطبخ في سوريا تحمل مسميات تركية إلى اليوم، مثل مدرج الخشب الخاص بترقيق العجين ويُعرف باسم “شوبق-شوباك”، وأداة غرف المرق من القدر تُعرف باسم “كماية”، وتلك التي تُستخدَم لالتقاط اللحم أو الخضار من القدر من دون أن يأخذ شيئًا من المرق، والتي تأتي دائرية الشكل بثقوب واسعة ومقبض طويل، وتُعرف باسم “كفكير”.
من أين جاءت العامية؟
يقول ياسين عبد الرحيم، في كتابه “موسوعة العامية السورية”: “تتمثل صعوبة معرفة أصل الكلمات المشتركة بين العربية وغيرها من لغات العائلة السامية، خاصة في الألفاظ المتبادلة بين العربية والآرامية أو وريثتها السريانية، لما بينهما من التداخل بحكم المجاورة منذ زمن ما قبل الهجرة النبوية والإسلام وانتشار العربية أكثر، وبحكم انتشار الآرامية على اختلاف لهجاتها فيما يُصطلح عليه جغرافيًا ببلاد الشام والعراق كلها”.
وقد تفرعت منها لهجات غربية كالآرامية الفلسطينية والنبطية في بترا وتدمر، وشرقية كآرامية التلمود البابلي وآرامية الصابئة (المندائية أو المندعية) في جنوب العراق، واللهجة السريانية التي تفرعت منها وازدهرت في مدينة “الرها” منذ ما قبل السيد المسيح ثم دخلتها المسيحية منذ القرن الأول.
ويضيف عبد الرحيم: “أثرت الآرامية في العربية تأثيرًا عظيمًا بألفاظها المتعلّقة بالصناعة والطب والكتابة، وبما توسطت في نقله إلى العربية من الأقوام الأُخرى، كما أثرت خاصة في المصطلحات الزراعية التي أخذ العرب معظمها حتى إن علم الزراعة ظل إلى وقت طويل بعد الإسلام يُسمّى عند العرب بـ(الفلاحة النبطية)”.
في الاقتراض اللغوي بين العربية والسريانية، يقول الباحث مار غناطيوس يعقوب، في بحث اقتبس منه عبد الرحيم، لموسوعته المذكورة، إن هناك الكثير من الألفاظ التي يتبدل فيها حرف السين شينًا في العربية، وبالعكس، نحو شمس التي تُلفظ “شمش”، في السريانية، ونفس التي تلفظ “نفشا” ومثلهما رأس.
كما أن التداخل الشديد بين العربية والسريانية يعد حالة قديمة لا يُعرف على وجه التحديد زمن بدئها، ويذهب أبو العلاء المعري في الصفحة 31 من كتابه “اللزوميات”، إلى القول على لسان آدم أبي البشر: “إنما كنت أتكلم بالعربية وأنا في الجنة، فلما هبطت إلى الأرض نقل لساني إلى السريانية فلم أنطق بغيرها إلى أن هلكت”.
هناك عدد من المعاجم العامية التي يمكن العودة إليها لاكتشاف حجم التداخل بين اللغات السامية ومؤثرات المحيط على ما نتحدث به اليوم من لغة محكيّة في سوريا، ومن المؤكد أن هناك معاجم تهتم بمحكيات بقية الدول العربية.
ومن أهم المعاجم المختصة بمحكيّة الشام: “معجم ألفاظ العامية اللبنانية” لأنيس فريحة، و”معجم رد العامي إلى الفصيح” للشيخ أحمد رضا، و”الدليل إلى مرادف العامي والدخيل” لرشيد عطية، و”قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية” لأحمد أبو سعد، و”غرائب اللغة العربية” للأب رفائيل نخلة اليسوعي، الذي له أيضًا معجم “غرائب اللهجة اللبنانية السورية”.