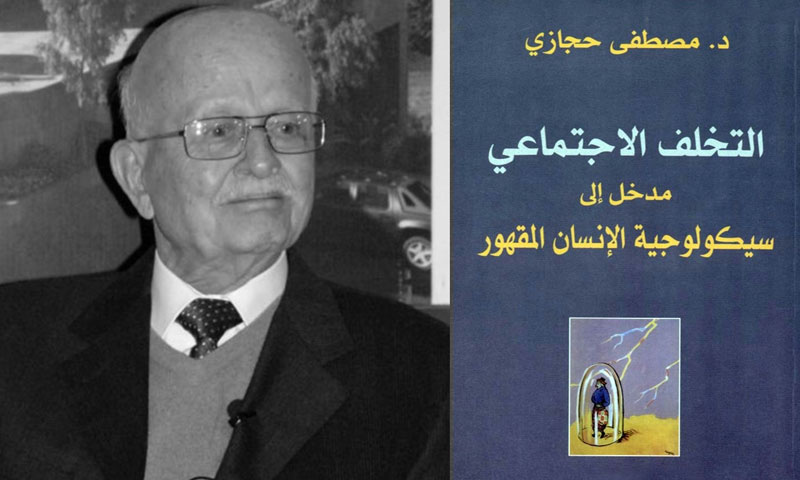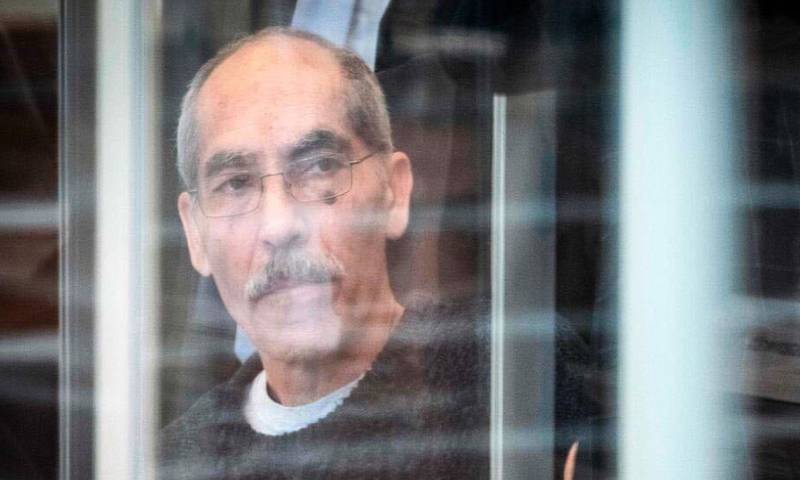الفراغ الكبير.. تحليل نفسي لبنية السلطة في سوريا
أحمد عسيلي
في صباح 8 من كانون الأول 2024، استيقظ السوريون على مشهد لم يكن ممكنًا تخيله قبل أيام فقط.
اختفى كل ما مثّل الدولة التسلطية: الجيش، الأمن، المخابرات، الفرقة الرابعة. اختفى الخوف المتراكم في الجسد، وتلاشت الأجهزة التي كانت تؤسس، عن طريق العنف، لعلاقة السوريين بالدولة، لكن خلف هذا الاختفاء المادي، كان هناك اختفاء أعمق وأكثر خطورة: اختفاء الأب الرمزي، كما يحدده التحليل النفسي، أي انهيار البنية التي نظمت لعقود العلاقة بين الجماعات السورية، وسوّت بينها على أساس من الخوف والتوازن القمعي، وجعلت الدولة التسلطية مرجعية رمزية عليا، حتى حين تمارس العنف، وحتى حين تغيب العدالة.
الصدمة الأشد، كانت من نصيب المجتمع العلوي الذي شكلت هيمنته على أجهزة القمع إحدى ركائز النظام، فجأة، وُضع هذا المجتمع في فراغ غير مسبوق، بلا دولة تحميه أو تحتكره، وبلا موقع واضح ضمن المعادلة الجديدة، وجد نفسه وجهًا لوجه مع مجتمع الأغلبية السنية، التي كانت تمثل أكثرية سكانية، لكنها كانت مقموعة عسكريًا وأمنيًا، كما وجد نفسه أمام علاقة ملتبسة مع الأقلية الإسماعيلية، التي شاركها العيش في الساحل، لكنها ظلت دومًا في موضع أدنى من حيث القوة والتمثيل.
لم تكن سلطة الأسد مجرد نظام أمني معزول عن البنى الاجتماعية، أسس حافظ الأسد لبنية سلطوية معقدة، مارست العنف، لكنها أيضًا قدّمت شكلًا من أشكال الترضية الرمزية لكل مكوّن. وأول من تعرض للقمع الكامل، كان المجتمع العلوي نفسه، الذي تمت عسكرته وتحويله إلى كتلة منضبطة خاضعة، بلا مجتمع مدني، بلا صوت خارج البنية القمعية، مقابل منحه الشعور بالسلطة.
أتذكّر حادثة حين كنت طالبًا في المرحلة الثانوية بمدينة طرطوس. كانت الشعبة تضم حوالي 45 طالبًا، أغلبيتهم من الطائفة العلوية، إلى جانب بضعة مسيحيين، كنا أربعة طلاب سنة فقط، وكان أستاذ التربية الدينية إمام جامع علويًا، يدرّس المنهاج السني الرسمي، دون أي مراعاة للتركيبة الطائفية الواقعية، وبلا أي نقاش حقيقي حر بطبيعة الحال، كان يشرح درس الحديث النبوي بطريقة لا تُقنعه هو، ولا تقنع أكثرية الطلاب، ومع ذلك، حين حاول أحدهم السخرية من شخصية إسلامية سنية، نهره الأستاذ بعنف، ودفعه للاعتذار وتكرار الكلام المنهجي بالحرف.
ظل هذا المشهد عالقًا في ذهني، لم أفهم يومها لماذا يفرض النظام خطابًا دينيًا سنيًا في صف، بل وفي مدرسة ومحافظة أغلبيتها الساحقة من العلويين، ومع مدرس علوي، وفي دولة يسيطر عليها نظام، تدير جهازه القمعي أغلبية علوية، بينما نحن الطلاب السنة لا نشكل أي تهديد، ثم لاحقًا مع دراستي للتحليل النفسي فهمت: لم نكن نحن من يُخشى منه، بل كانت تلك السياسات المقنّعة، أدوات متقنة لإعادة إنتاج التوازن السلطوي، فالنظام منح أبناء الطائفة العلوية أدوات القمع، وسلبهم أدوات التعبير والثراء، وترك الخطاب الديني الرسمي في يد الأغلبية السنية، في توزيع دقيق للأدوار، النتيجة كانت مجتمعات مقموعة ومجردة من الفعل، لكنها تشعر بالسلطة من خلال الأجهزة الأمنية، كما في أحياء مثل “المزة 86” في دمشق، سلطة بلا امتياز (الخدمات العامة في تلك الأحياء كانت في حدودها الدنيا) وهيمنة بلا مال، فالفقر كان على أشده في تلك المناطق.
أما في السويداء، فكان المشهد مختلفًا، فقد نجح المجتمع الدرزي، بشكل استثنائي، في الحفاظ على استقلال رمزي عن مركز الدولة، دون أن يعلن تمرده الكامل عليها. نال “الصوت الكامل” في التعبير عن خصوصيته، واحتفظ بمسافة محسوبة من النظام، دون أن يقطعها تمامًا، ولعل هذا التوازن لم يكن مجانيًا، فقد جرى تهميش مجتمعي وسياسي كبير للبدو في محيط المدينة، بل ولسنة ومسيحيي المركز، وكأن النظام اشترى ولاء شريحة مركزية من الدروز بتركهم يديرون حدودهم وحدهم، شرط ألا يعبروا تلك الحدود.
الآن، انتهى كل ذلك، وبتنا أمام واقع جديد، دولة لم تعد تملك أدوات القمع القديمة، أو على الأقل لم تعد تمارس خطابها، هناك هامش حريات متفاوت، يزداد وينقص يوميًا، ودولة في طور التشكل، هنا، لا بد من أن نضغط جميعًا، كي لا تكون هذه الولادة مجرد استبدال وجوه، بل تأسيسًا حقيقيًا لدولة الحقوق والمساواة.
لكن النضال السياسي، رغم أهميته، ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، فالجزء الأخطر، والأكثر رسوخًا، هو تلك البنية النفسية والاجتماعية التي تحكم العلاقة بين المكونات السورية المختلفة: السنة، العلويين، الدروز، الإسماعيليين، المسيحيين والكرد وغيرهم، فلعقود مضت، جرى تسميم هذه العلاقات بالخوف، بالاتهام، بالحذر المزمن، وتم التلاعب بها بكل براعة من قبل النظام، الذي تسلل عبر تلك الفجوات التي فصلت بينهم. أعطى بعضهم السلطة، وسلبهم المعنى. منح آخرين الخطاب، وسلبهم الفعل.
ولكيلا تتكرر المأساة، لا بد من فتح حوار مجتمعي عميق، يتناول المظلوميات التي راكمها التاريخ السوري لدى كل مجموعة، دون إنكار أو تهرب. نحتاج إلى مصالحة حقيقية، لا تُفرض من فوق، بل تُبنى من الأسفل، من القرى والمدن، من المدارس والجامعات، من ساحات التظاهر والمقاهي. نحتاج إلى نزع الخوف، لا من الدولة فحسب، بل من بعضنا البعض.
فقط عندما ننجح في سدّ تلك المنافذ التي تسلل منها الاستبداد، يمكننا الحديث حقًا عن دولة جديدة، دولة لا تعيد إنتاج الأسد، بوجه جديد، أو طائفة جديدة، أو شعار جديد، بل تقطع جذريًا مع كل ما مثّله من انقسام وخوف، وأداء كل مجموعة لدورها المفروض عليها من أعلى.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :