مروان فرزات – عنب بلدي
“عندما أنظر إلى الدمار في سوريا وليبيا والعراق واليمن، يصعب علي أن أتخيل وجود حكومات مركزية في هذه الدول قادرة على ممارسة سيطرة أو سلطة على الحدود التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية، الحل العسكري مستحيل في هذه الدول”.
هذا ما قاله رئيس الاستخبارات الأمريكية، جون برينان، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيريه الفرنسي في مؤتمر للاستخبارات دعت إليه جامعة جورج واشنطن في تشرين الأول 2015.
وهذا ما بشرت به وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، مسبقًا في حزيران 2006، عندما صرحت من تل أبيب لأول مرة بمصطلح “الشرق الأوسط الجديد”.
فماذا يعني الشرق الأوسط الجديد في العقل الأمريكي؟
بعد خسارة السلطنة العثمانية للحرب العالمية الأولى قسّمت فرنسا وبريطانيا مناطق جنوب السلطنة، فيما عرف باتفاقية سايكس بيكو الشهيرة، لبسط سيطرتهما على هذه المنطقة الجغرافية المهمة من العالم، وإعلان الانتداب الذي استمر قرابة ربع قرن، وانتهى بخروج الاحتلال من بلاد الشام والعراق.
لكنّ الاستعمار، بعد خروجه من مناطق احتلاله في آسيا وإفريقيا، خلق مجموعة من بؤر التوتر بين الحدود الجديدة التي رسمها، كما في كشمير بين الهند والباكستان، لواء اسكندرون بين سوريا وتركيا، ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، حلايب وشلاتين بين مصر والسودان، وترسيم الحدود العراقية الكويتية، وغيرها من بؤر النزاع التي تركها الاستعمار عمدًا لتكون بابًا يعود منه لهذه المنطقة مستقبلًا.
لكن ما أفشل هذا المخطط هو بروز الولايات المتحدة الأمريكية، كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية، وتراجع دور فرنسا وبريطانيا لصالح هذه القوّة غير الراضية عن التقسيمات الحالية في الشرق الأوسط، كونها لم تكن مشاركة في وضعها، والتي تخطط الآن لإعادة رسم خارطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، لهذا بدأت مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، تعدّ الخطط والدراسات لإعادة رسم هذه الخريطة وتقدمها لمراكز صنع القرار الأمريكي، ومن أشهر الدراسات التي ظهرت للعلن هي خطة أوديد يينون التي نشرت في مجلة “كيفونيم” الصهيونية عام 1982، وهي خطة إسرائيلية تهدف لتقسيم سوريا ولبنان والعراق لدويلات تحكمها عصابات تابعة لإسرائيل تمهيدًا لتحقيق حلمها بأن تكون حدودها من الفرات إلى النيل.
ومن هذه الخطط أيضًا خطة الضابط الأمريكي من أصل بريطاني برنارد لويس، لتقسيم منطقة الشرق الأوسط على أسس عرقية وإثنية والتي نشرتها لأول مرة مجلة وزارة الدفاع الأمريكية عام 1992.
ومنها أيضًا خطة الكولونيل الأمريكي المتقاعد رالف بيترز التي نشرت عام 2006 والتي تهدف إلى تفتيت السعودية وإيران وباكستان، باعتبارها منبع الإرهاب، كما يقول.

لكن هل اتُّخذ القرار الأمريكي بتغيير خارطة الشرق الأوسط؟
بدأ تنفيذ المخطط فعليًا منذ أن دعمت الولايات المتحدة الحرب العراقية- الإيرانية عام 1980، لإنهاك أكبر قوّتين بالمنطقة في ذلك الوقت، وما تبعها من حرب الخليج الثانية التي ثبّتت بها أمريكا قواعدها في المنطقة بقوّة.
ثمّ انتقلت لمرحلة التنفيذ المباشر للخطة عام 2001، عندما غزت القوات الأمريكية أفغانستان لخلق بؤرة توتر دائمة في تلك المنطقة، وتبعها احتلال العراق عام 2003 وتسليمه على طبق من ذهب لإيران، لإذكاء نار العداء بينها وبين العرب وإخراجها من جحرها تمهيدًا لاصطيادها لاحقًا.
ومع انطلاقة الربيع العربي سارعت الولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع الثوار لمواصلة تحركهم، الذي سيخلق مراكز توتر ونزاعات جديدة في المنطقة، تستثمر لاحقًا في مشروع الشرق الأوسط الجديد.
كيف سيتم تنفيذ هذا المشروع؟
لتنفيذ هذا المشروع يجب أن تتوافر عدة عوامل:
- إخراج مناطق واسعة خارج سيطرة الأنظمة الحاكمة المستبدة.
- إيجاد تنظيمات عابرة للحدود في المنطقة لمسح الحدود القديمة وإحلال حدود جديدة مكانها، كما فعلت داعش عندما أزالت حدود سايكس بيكو بين سوريا والعراق أمام مرأى العالم كله دون أن يحرك أحد ساكنًا، وكما فعل حزب الله اللبناني عندما سيطر على مدينتي القصير ويبرود انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، وكما تفعل الوحدات الكردية المدعومة أمريكيًا.
- الحفاظ على توازن القوى في المنطقة لإبقاء النزاعات مستمرة، واتباع سياسة “الفوضى المنضبطة”.
- غض النظر عن التدخلات من الدول الإقليمية بهدف توريطها أكثر في الصراع.
شكل المنطقة الجديد
إنّ إطالة أمد الأزمة في المنطقة ولّد واقعًا جيوسياسيًا جديدًا، وأنظمة حكم محلية على طول الخريطة السورية والعراقية لا يمكن أن تزول بسهولة، لكن بعد انتهاء العاصفة في منطقتنا وانتقالها لمكان آخر ستظهر معالم هذا الواقع بشكل جلي، إذ سنرى مجموعة أقاليم اقتصادية لا إثنية ولا عرقية، فلا يوجد شيء اسمه تقسيم في المنطقة، بل إعادة رسم خريطة جديدة لتشكيل هذه الأقاليم التي ستمتد من أفغانستان شرقًا وحتى المغرب العربي غربًا.
فقد نرى الموصل مع الرقة في إقليم واحد، كذلك دمشق وبيروت في إقليم، والسويداء ودرعا والقنيطرة في إقليم واحد مع أجزاء من ريف دمشق، وحمص وطرطوس لوحدهما، أما حلب فستكون مع أجزاء من ريفها إقليمًا مستقلًا، كذلك دير الزور والبوكمال مع القائم العراقية، أما الحسكة مع القامشلي تضمّ إلى أجزاء من ريف حلب الشرقي.
هذه الأقاليم الاقتصادية لن تكون مستقلة القرار بل ستخضع معظمها لوصاية دولية وإقليمية، ومع انتهاء الحرب وعودة الاستقرار إلى هذه الأقاليم ستبدأ بالتفكير إما بالبقاء على شكلها ووصايتها الحالية، أو إعادة الاندماج مع أقاليم مجاورة، أو من الممكن أن تعود وتشكل الخريطة القديمة التي عرفتها سابقًا، فكون الاقتصاد هو عماد كل دولة فلن تستطيع معظم هذه الأقاليم الاستمرار في نظامها الاقتصادي دون أن تتحد مع إقليم آخر أو أكثر، لاعتماد الاقتصاد السوري طيلة العقود الماضية على التكامل بين هذه المناطق.
كل هذه الفرضيات مرهونة بانتهاء الحرب في سوريا والعراق، لكن لن تنتهي الحرب هنا قبل أن تبدأ في دول أخرى من الشرق الأوسط، وخاصة الدول المجاورة التي ستبدأ فيها المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية للشرق الأوسط كون الأرض باتت خصبة في هذه الدول.
فماذا ترى بقية دول العالم؟
ترى معظم الدول العظمى أن الاقتصاد العالمي بحاجة دائمة إلى نزاعات وحروب في مناطق من العالم فليس من المعقول أن تكون هذه الحروب على حدودها في أوروبا وأمريكا، ومن هنا اختيرت منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك البيئة الخصبة والأرضية الجاهزة التي اكتملت مع تحول بعض ثورات الربيع العربي إلى نزاعات مسلحة لاستنزاف هذه المنطقة لأقصى حد ممكن.
فالروس مثلًا، دعموا النظام السوري بشتى الوسائل العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، لكن في المقابل استولت روسيا على ثروات الغاز والنفط شرقي حمص وعقود اقتصادية طويلة الأمد للتنقيب عن الغاز المكتشف حديثًا في البحر المتوسط قبالة الساحل السوري.
ولم تكتفِ روسيا بهذا بل أنشأت قاعدة عسكرية جديدة في سوريا في حميميم بريف اللاذقية، لتحافظ بشكل دائم على وجودها في المنطقة.
ليس من مصلحة روسيا أن تقسم سوريا إلى عدة أقاليم أو دول فهي كانت سابقًا حليفًا لسوريا ولا تريد أن تخسر أي جزء منها لصالح دول منافسة، لذلك حاولت التدخل بشكل مباشر في الحرب لصالح حليفها النظام السوري وبنفس الوقت سعت لعقد مصالحات في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وفي الكثير من هذه المناطق قدمت نفسها كطرف ضامن وضاغط على نظام الأسد.
لكن هذا التدخل العسكري المباشر أصبح مكلفًا للاقتصاد الروسي الذي لا يحتمل أي ضربات جديدة، خاصةً مع خفض أسعار النفط عالميًا لذلك قد لا تمانع روسيا من رسم حدود جديدة كحلّ للأزمة السورية بما يحفظ هيمنتها على منطقة الساحل السوري، التي توجد فيها قاعدتا طرطوس وحميميم الروسيتان، ما يمنع عرقلة مد خطوط الغاز القطرية باتجاه أوروبا ويجعل روسيا شريكًا أساسيًا بمشروع خط الغاز المقترح إنشاؤه من إسرائيل حتى ميناء جيهان التركي لتصدير الغاز الإسرائيلي المكتشف حديثًا.
أما بريطانيا فلم ولن تنسى أن إمبراطوريتها كانت الشمس لا تغيب عن أراضيها لذلك ابتعدت عن منطقة الشمال السوري التي تغص بالقواعد الأجنبية واختارت لنفسها منطقة التقاء الحدود السورية بالعراقية والأردنية، عند نقطة التنف لتبني بالاشتراك مع الولايات المتحدة قاعدة عسكرية لها في المنطقة، تكون بوابة لهيمنتها على مناطق دير الزور والبوكمال والقائم، التي كانت تخضع لوصايتها سابقًا، وتكون بذلك بوابة لها للهيمنة على منطقة البصرة لاحقًا.
بينما تريد فرنسا العودة للمنطقة من خلال مكافحة الإرهاب، ففرنسا اليوم هي ثاني أكبر قوة في التحالف الدولي ضد داعش، بعد الولايات المتحدة، لهذا أنزلت فرنسا قواتها في عين العرب وأعينها مسمّرة على مطار منّغ العسكري شمال حلب، ليكون قاعدة عسكرية أساسية لها في سوريا.
لكن سرعان ما اصطدمت أحلام الفرنسيين بالتدخل التركي المباشر في المنطقة، والذي حظي بضوء أخضر روسي- أمريكي، لأسباب خاصة بكل دولة، فالروس لا يعنيهم هذا التدخل كثيرًا كون النظام السوري، حليف الروس، بعيدًا عن هذه المنطقة، ومن ستقاتلهم تركيا هم داعش والبي ي دي الحليف الأمريكي في المنطقة، ناهيك عن أن هذا التقارب الروسي- التركي يمكن أن يثمر على المدى البعيد إخراج تركيا من حلف الناتو، لصالح تشكيل حلف قوي في المنطقة يضم، بالإضافة لروسيا وتركيا، كل من إيران ومصر.
بينما ترى أمريكا أن إعطاء تركيا هامش قرار للتدخل في سوريا سيزيد من غرق الأتراك في الوحل السوري، ما سينعكس سلبًا على الداخل التركي الذي يعاني العديد من الاضطرابات، أهمها حالة الحرب الحقيقية التي تعيشها شرق البلاد مع انخفاض قياسي لصرف الليرة التركية أمام الدولار.
لكن الأتراك لن يفوتوا هذه الفرصة التاريخية، ليعيدوا أمجاد السلطنة العثمانية من بوابة الموصل وحلب، خاصةً مع اقتراب إيران المنافس الإقليمي من السيطرة على المدينتين، مستغلةً أيضًا الظرف الدولي والصمت الأمريكي على تدخلها المباشر في المنطقة لتحقق حلمها في إعادة أمجاد فارس، بعد وصل طهران ببيروت مرورًا ببغداد ودمشق، فطهران تعلم مسبقًا أن تحولها إلى دولة كبرى لا يمكن أن يتم ما لم يصل نفوذها للمتوسط، الذي سيمكّنها لاحقًا من مد خطوط النفط والغاز لأوروبا لتطبيع علاقاتها مع الأوربيين ولتفرض نفسها كلاعب قوي في المعادلة الدولية.
ولضمان استمرارية هذا المشروع اتخذت إيران من نشر التشيّع وسيلة لتحقيق الهدف، عن طريق تغيير ديموغرافية المنطقة بأدواتها من الشيعة العرب، فليس من السهل أن تحوّل العربي لفارسي بيوم وليلة، لذلك كان لا بد من المرور بمرحلة التشيّع للوصول لهدفها المنشود.
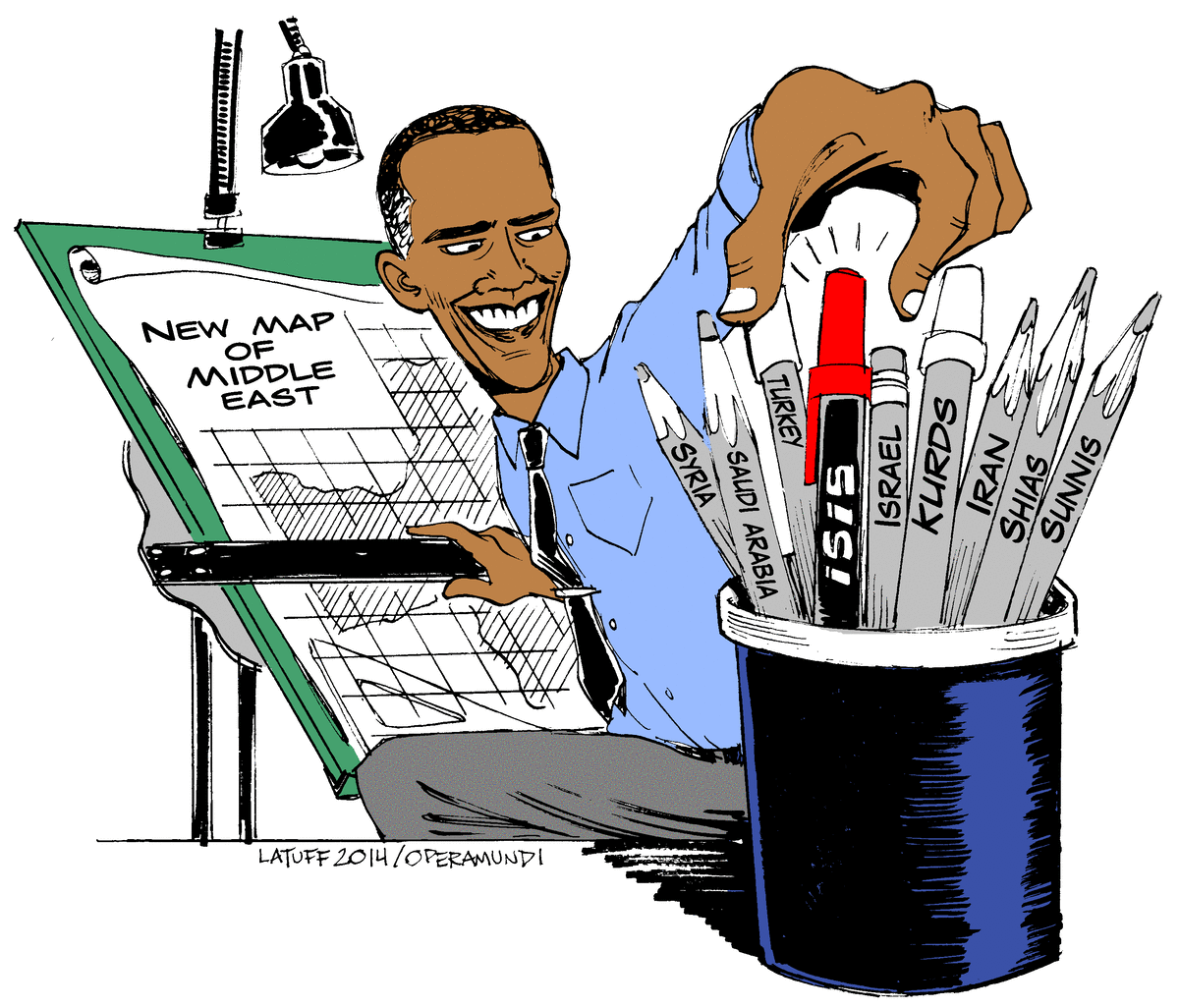
أين العرب من هذه المشاريع؟
إن مصطلح “الأمن العربي” غير وارد أبدًا في أذهان أي من الدول العربية، لذلك تسعى جميع هذه الدول للحفاظ على أمنها الوطني فقط، ولهذا اقتصر الدعم الخليجي للثورة السورية على المال والأسلحة الخفيفة فقط، دون أي تنسيق بين هذه الدول الداعمة، فكل دولة تدعم فصيلًا معينًا دون غيره، وفي كثير من الأحيان تتقاتل هذه الفصائل فيما بينها كما حصل في ريف دمشق منذ أشهر، بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام، وكما حصل منذ ثلاث سنوات بين الجبهة الإسلامية وقيادة أركان الجيش الحر، فيتحول الدعم بذلك لصراع نفوذ بين هذه الدول.
بينما تراه في اليمن يأخذ شكل التحالف العربي الموحد ضد الحوثيين كون اليمن تعتبر أكثر أهمية من سوريا من حيث التأثير على الأمن الخليجي ككل والسعودي بشكل خاص، فالمملكة اليوم مهددة أيضًا أن تمر بها رياح التقسيم في الخريطة الجديدة.
أما مصر التي تمتلك أهم جيش في المنطقة، فهي معنية أيضًا بمشروع الخريطة الجديدة من بوابة سيناء المرشحة أن تكون مركز صراع جديد، خاصةً بعد أن قام الجيش المصري بحملة عسكرية هدمت الأنفاق التي تعتبر عماد اقتصاد سكان المنطقة بخطوة استفزازية كبيرة لأهلها، نَبّه هذا الحدث وما تبعه من سقوط لطائرة ركاب مدنية روسية، المملكة العربية السعودية لما يحاك لهذه المنطقة التي تعتبر أيضًا ضمن دائرة الأمن الوطني السعودي لتقدم لمصر العديد من المنح المالية لتنمية شبه الجزيرة المصرية، من خلال بناء مصانع وجامعات ومنشآت سياحية وربطها برًا بالسعودية، عبر جسر بري يمر فوق مياه البحر الأحمر، لكن هذا المشروع لم ولن يبصر النور مع وجود إسرائيل التي تضع سيناء وثرواتها ضمن أهم خططها التوسعية في المنطقة.
نلاحظ مما سبق كمّ المشاريع والمخططات التي تحاك لمنطقة الشرق الأوسط، والتي شاء القدر أن تكون سوريا مركز الزلزال الذي سيغير حدودها، ليرسم بالدم حدودًا تبقي في ذاكرة شعوبها سنوات من الألم دُمّر فيها الحجر والبشر، وقطّعت أوصال البلد الواحد لتشكل أقاليم صغيرة منغلقة على نفسها استقر فيها سكان من مختلف المناطق المحيطة بعد أن اعتقدوا أن نزوحهم إليها مسألة وقت ليجدوا أنفسهم محاصرين بواقع لا يمكن لهم إلا أن يتعايشوا معه، فيكون الحنين لمسقط رأسهم هو الطريق الذي سيسلكونه للوقوف بوجه كل هذه المخططات وإعادة توحيد الخريطة السورية.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :




 امرأة ترفع أصابع النصر إثر قصفٍ نفذّته مقاتلات أمريكية على مدينة كوباني على الحدود السورية- التركية
13 تشرين الأول 2014
(AP)
امرأة ترفع أصابع النصر إثر قصفٍ نفذّته مقاتلات أمريكية على مدينة كوباني على الحدود السورية- التركية
13 تشرين الأول 2014
(AP)


